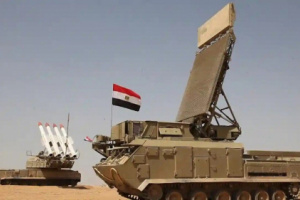مقالات
تساؤلات العشرية المعلقة

منذ عشر سنوات سوداء، والبلاد تعيش تحت ظلال الأسئلة المؤجلة:
أين تذهب موارد الدولة منذ بداية الحرب؟ وأي المحافظات امتنعت عن التوريد كلياً أو جزئياً، ولمصلحة من ذهبت وما تزال تذهب تلك الإيرادات؟ أسئلة تبدو بديهية، لكن الإجابات عليها تحولت خلال سنوات الحرب إلى أسرار معتمة لا يملك المواطن حق الوصول إلى تفاصيلها.
وتتوالى التساؤلات حين تقترب من مركز صناعة القرار: من يرسم السياسات المالية والنقدية للدولة، وكيف ولماذا تفككت الروابط الاقتصادية والمالية بين المحافظات حتى أصبحت أرخبيلاً من الجزر المفككة، تعمل كل واحدة بمنطقها الخاص؟ وما الذي مهّد لظهور “خصخصة مقنّعة” طالت مؤسسات إيرادية سيادية، فصودرت أدوارها وتم تفريغها من وظائفها؟ ومن أشعل شرارة هذا المسار، ولماذا ظل كل شيء طي الصمت، يُرى ولا يُقال عنه مثقال حرف نابض بالحقيقة؟
ويتعمق الغموض أكثر عند الوصول إلى ملف الإنفاق العام: ما حجم موازنات الرئاسة والحكومة؟ من يقترحها ويصادق عليها؟ ومن يراقب صرفياتها الفعلية؟ وكم تنفق السلطة خارج اللوائح المالية والإدارية؟ وما حقيقة مصروفات الإعلام الموجّه وخلاياه المنتشرة في الداخل والخارج؟
وفي زاوية أخرى لا تقل ثقلاً، يتضخم السؤال حول المسؤولية المباشرة عن الانفجار غير المسبوق في تعيينات الوكلاء والمستشارين والمسميات الوظيفية المبتكرة داخل الوزارات والمحافظات، وعن الآليات الضبابية التي تُدار بها التعيينات في البعثات الدبلوماسية.
هكذا تتكدس الأسئلة وتتشابك الملفات، فيما تبقى الإجابات إما غائبة أو محجوبة أو جزئية، وكأن عشرية كاملة من الفوضى الإدارية والمالية قد تعمقت وظلت بلا رقابة أو شهود، لتقود في النهاية إلى مشهد العجز عن دفع رواتب موظفي الدولة.
وثمة بالطبع أسئلة أثقل من تلك: عن أسباب فشل التحالف العربي والجيوش الوطنية، وكيف وصل حال البلد إلى ما وصل إليه حتى إن الشرعية بما فيها المجلس الانتقالي لا يملكان من أمر الحرب والسلام غير التبعية والامتثال الكامل.
من سرق صوت الحقيقة؟ ومن صادر حق الناس في أن يعرفوا ما يُفعل باسمهم؟
على مدى عقد من الزمن، عاشت المناطق المحررة تجربة قاسية من التضليل الإعلامي، حيث غابت الحقيقة تحت ركام الضجيج، وتحولت معاناة الناس إلى مادة للتوظيف السياسي. فبدلاً من أن يكون الإعلام مرآة للواقع، صار أداة لتشكيله على مقاس المصالح، وتحوّل بعض الإعلاميين وصانعي المحتويات من شهود على المرحلة إلى مفبركي حكايات وإيحاءات تبرّئ هذا وتجرّم ذاك وفق الحاجة.
لقد أصبحت الكلمة في بعض المنصات أخطر من السلاح في الحرب الجارية، لأنها تقتل أو تجرح وعي الناس وتحبط اجتهاداتهم في البحث والكشف، وتغوي نواياهم السليمة في رحلة استبصار ما يحدث في الواقع الحزين، عدا عن أنها تبني في العقول واقعاً زائفاً يخدّر الضمائر ويعيد إنتاج الوقائع بمعان ملفقة.
وهكذا، في بلد نُهبت موارده تحت عنوان “الشرعية”، سُرقت الحقيقة أيضاً، وصارت توزَّع بالحصص السياسية وتُخزَّن في أرشيف الولاءات. وفي ظل غياب الدولة، تحوّل حتى الإعلام الرديء إلى سلطة موازية تتولى تغييب الإجابات الصحيحة عن أسئلة حيوية.
هناك خطوط مواجهة تُزهَق فيها الأرواح لترحل إلى بارئها تاركة خلفها عائلات دامعة بائسة، وهناك خطوط مساومة تُباع فيها المواقف وتشترى، وهناك أيضاً خطوط منافسة على المسؤوليات والمناصب يُقرّب إليها الأقربون وفقاً للمزايا التي تروق لصاحب القرار… وهناك شعب مرابط ينتظر أفقاً يستجلي من خلاله مصائره الغائمة.
الخطر اليوم لا يكمن في ضياع الثروة وحدها، بل في ضياع البوصلة الأخلاقية التي تميّز بين من يقول الحقيقة ومن يصنعها على مقاس وليّ النعمة.
فالبلد الذي يُنهب فيه الوعي لا يمكن أن ينهض، لأن الخراب الحقيقي لا يبدأ من عجز الموازنات، بل من عجز الضمائر. وحين تترنح الحقيقة تحت سياط الميديا والإعلام المغشوش، تصبح الأوطان ساحة لتنازع الروايات وتزاحم المموّلين، ويغدو الوطن ضحية تبحث عمّن يروي الحكاية دونما ثمن.