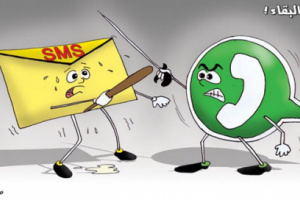تقارير
‘‘السعودية 2030‘‘.. عبور شاق وخطوة تاريخية كبرى، لها ما بعدها

يمكن اختصار الرؤية "السعودية 2030" بأنها طموح صعب، وتحدٍّ تاريخي، يقوم على إدارة الاقتصاد السعودي بنظرةٍ جديدةٍ مبنيةٍ على المملكة نفسها، شعباً وجغرافيا ومكانة وموارد كبيرة ومتنوعة، وتجري تحت هذا العنوان تغييراتٌ جذريةٌ في تنظيم القدرات الاستثمارية وتوسيعها، واستغلال موارد متعدّدة، وتنمية قطاعات جديدة، وإعادة النظر في ثوابت اقتصادية، ظلت تهيمن على دورة الحياة العامة والخاصة، منذ عقود طويلة.
هناك مؤشرات كثيرة تدلّ، بشكل قطعي، على أن المملكة أدركت، لعوامل داخلية وخارجية وتحديات كبيرة، أنها أمام انتقالٍ محتومٍ من حالة المحافظة على تاريخ نمطي في الإدارة والعلاقات والتحالفات، لتخرج من شرنقتها التاريخية إلى طور الحياة المتجدّدة، ربما سيضع حاضرها على خط سير نحو آفاقٍ، تعيد صياغة هذا البلد الكبير الغني المحافظ بشكل عصري ونموذجي، ليأخذ مكانته الحقيقية، مستثمراً كل خزائنه المادية والمعنوية، واستخراج محتوى مكامن القوة الحقيقية.
الإدمان على النفط كمصطلح ظهر في الرؤية، وفي حديث ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استخدمه كتاب أميركيون بشكل خاص، في مستهل العقد الماضي، لنقد حالة الاعتماد والانكفاء على النفط الرخيص، وحالات ما أسموها المجاعة النفطية للدول الكبيرة، حين كانت رياح التهويل حول إمكانيات نضوب الاحتياطات النفطية تضرب ميادين الفكر، بشكلٍ حرّك العلماء باتجاه البحث عن بدائل، وربما جاء تطوير تقنيات النفط الصخري نتيجة ذلك الحراك المشوب بالمخاوف حول مستقبل الطاقة حينها. ومع ذلك، تبقى التسمية، في الحالة السعودية، توصيفاً دقيقاً، لأن الدولة هناك انحصرت في اعتمادها على دخل النفط الذي شكل %90 من إجمالي الانتاج المحلي عقوداً عدة، حتى أصيبت بحالةٍ من الاسترخاء، أو الكسل الذهني والفيزيائي، إلى حدٍّ جعل من النفط متلازمةً حيويةً وصفةً للمملكة، لا يراها الآخرون إلا من خلاله، تستهويهم رائحته تارة، وتنفرّهم تارة أخرى، وكأنها تحيا به، وتتلاشى بدونه، وهو وضعٌ مخالف للحقيقة، لأن لدى السعودية إمكانات غير محدودة، ومصادر رئيسية وثانوية كثيرة، تجعل منها واحدةً من أكبر الاقتصاديات في العالم.
تسعى السعودية، إذاً، إلى الخروج من عباءة النفط، وليس من حالة الإدمان فقط، ولها أن تتجلى بمظاهرها المتعددة، ونموذجها الحديث، لأن أهلها ومعهم العرب، منذ تواريخ خلت، انتظروا بكل ألوان صبرهم أن تظهر المملكة الجديدة بمشروعها الريادي في الإقليم والعالم، وتضع خلف مسيرتها عاداتٍ سادت، قيدت المملكة داخل جلباب النفط والحلفاء التقليديين، وفرضت عليها قواعد الحركة وحدود الفعل في مواجهة تحدياتٍ داخلية وإقليمية عديدة، ما جعلها تهدر كثيراً من إمكاناتها وبعض مكانتها.
تشتمل رؤية السعودية 2030 على أهداف كبيرة جداً، بحيث يصبح الطموح معها وصفاً "مجرد البدء بهذا المشروع الضخم، بجرأةٍ وشجاعةٍ، خطوة تاريخية كبرى، لها ما بعدها" متواضعاً، وهي مواجهة صعبة وحساسة جداً، حين يدرك القارئ المتعمق لتلك الرؤية أنها ستنقل المملكة عبر 15عاماً فقط، مقسمة على ثلاث مراحل، إلى دولةٍ متحرّرةٍ تماماً من الاقتصاد الريعي، تتشارك، بشكل متكافئ، مع الاقتصاديات الكبرى في قيادة النظام الاقتصادي العالمي، ليس من زاوية الإملاءات النفطية. ولكن، من مستويات الندية، حين تبلغ نسبة الصادرات المحلية غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي %50، وهي قفزة كبيرة تحتاج إلى رفع القدرة الاستثمارية، وقيمة أصول الصناديق وتمكينها من تمويل المشاريع الكبرى المختلفة، وتطوير المصادر الجديدة من القطاعات الصناعية والتعدين والعقارات والسياحة بمختلف أوجهها. وهذا، بالطبع، يتطلب قدرات مالية ضخمة، بشكل أو بآخر، وبحث عن مصادر جديدة في مقدمتها عوائد خصخصة جزء من أصول الدولة، وهو إجراء في منتهى الأهمية، كونه يحمل بعداً اجتماعياً يقتضي الشفافية، واستهداف الطبقات الدنيا والوسطى بصورة رئيسة، ويفتح الأبواب أمام الرأسمال الوطني والأجنبي.
تعتبر شركة أرامكو من أكبر الشركات العامة للبترول في العالم، وتمتلك أصولاً ضخمة، من الصعب تقييمها بالأرقام المالية، إلا وفق حسابات بسيناريوهات مختلفة، لكنها، في التقدير العام، كما ورد، ربما تتراوح قيمتها بين 2 و 3 ترليون دولار أميركي، وهو رقم مرن جداً، لأن الشركة، وفق قراءات مختلفة لأداء النفط 15 عاماً (وهو زمن الرؤية) يمكن أن تتجاوز أصولها تلك القيمة التقديرية. ذلك يعني أن خصخصة 5% من أصول "أرامكو" ووضعها للاكتتاب الداخلي والخارجي قد يحدث تسونامي مالياً في وقت قصير، ويشكل مصدراً مهماً في مسار تنمية الاقتصاد الإنتاجي اللاريعي السعودي.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل أي نهضة اقتصادية عن شركة أرامكو نفسها، حتى وإن كان توجه الاقتصاد في الرؤية سيذهب باتجاه القطاعات غير النفطية، فالشركة بحاجة ماسةٍ إلى خوض تجربة الصناعات المحلية لتقنيات متعددة، تدخل في المنشآت الاستخراجية والبتروكيماويات والمصافي والبنيات التحتية للخزن والتسويق وغيرها، المعروفة في منظومة الصناعات البترولية، حيث قطعت بلدانٌ أقل شأناً من نظيرتها السعودية في الاحتياط والقدرة الإنتاجية أشواطاً كبيرة في هذا القطاع المهم، مثل شركات ستات أويل ونورسك هيدرو النرويجية وشركة برازبترو البرازيلية، بالاضافة إلى مؤسسة البترول الصينية سينوبيك، وغيرها من شركات عامة أصبحت تنتج وتصدر تقنيات كبيرة وعالية الكفاءة والجودة في صناعة الاستكشاف والاستخراج من المناطق القاريّة والبحور العميقة. وإذا ما تم ذلك إلى جانب البدء في مشاريع الطاقة النووية للأغراض السلمية، كجزء من مشروعات الطاقة البديلة المتنوعة، فإن الرؤية تصبح بمعايير العصر مشروع نهضة متكامل الجوانب وتاريخياً بفرادته.
تحتاج تلك الرؤية والبرامج التنفيذية التي سيتم إنجازها، بالطبع، إلى منظوماتٍ مختلفة من الإصلاحات وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وطريقة الحوكمة وإعداد التشريعات والقوانين واعتماد الشفافية ومحاربة الفساد، وغيرها من الشروط الضرورية لنجاح الدورة الاقتصادية الكبرى، ناهيك عن اعتماد إجراءات موضوعية لتقنين المصروفات الضخمة بأنواعها، بالإضافة إلى تهيئة المجتمع السعودي، بصورة موضوعية، للتفاعل مع القيم الاقتصادية الحديثة، والتي تتطلب حراكاً ثقافياً منفتحاً بشكل عقلاني على متطلبات الانتقال نحو اقتصاد ضخم ومتنوع ومشارك مع الاستثمارات المتعددة الجنسيات.
يجب أن لا تتجاوز الرؤية السعودية للأعوام المقبلة حقيقة التكامل الإقليمي، والمكملات الجغرافية والطبيعية الاستراتيجية إن صح التعبير، لرفع المكانة العملية لخارطة المملكة على الأرض، وربطها بالممرات المتنوعة والآمنة في محيطها الخليجي وجوارها العربي. وبصورةٍ ملحةٍ، يتعين النظر جنوباً أيضاً، لأنه بلا شك أمر يدخل ضمن الامتدادات الحيوية الاستراتيجية.
لا أحد يجزم، الآن، كيف ستكون رحلة العبور الشاقة التي لا تخلو من المخاطرة الاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التأسيس في السنوات الخمس الأولى، لأنها الأهم. ولكن، نعتقد أن مجرد البدء بهذا المشروع الضخم، بجرأةٍ وشجاعةٍ، خطوة تاريخية كبرى، لها ما بعدها.
*- د أحمد عبداللآه – خبير نفطي – كاليجاري كندا