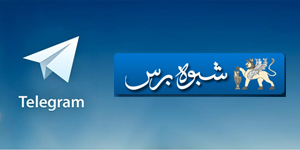مقالات
الإخوان.. عدو هنا، حليف هناك

التناقض يمتد إلى الخطاب الديني والأمني حيث يُطلب من جهات أمنية التعامل مع الجماعة كخصم لا يمكن التفاوض معه في الوقت الذي تنسج فيه مؤسسات سياسية علاقات من خلف الستار معه.
في عالم السياسة، لا يندر أن نجد تناقضًا بين القول والفعل، بين الشعارات والمواقف، لكن حين يتحول التناقض إلى نهج، يصبح السؤال عن “المبدأ” أشبه بمحاولة العثور على ضوء في مرآة معتمة، ذلك ما يبدو عليه حال التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين في بعض العواصم المؤثرة، التي تتعامل معهم في بلد على أنهم تهديد وجودي، وفي بلد آخر على أنهم شركاء أمر واقع، يمكن التحالف معهم تحت عنوان “المصلحة العليا”، وإن مؤقتًا.
في المشرق، وعلى مقربة من نهر الزرقاء، يُعامل التنظيم بوصفه قوة يجب تحجيمها لا فقط سياسيًا، بل إعلاميًا ونفسيًا، البيانات تُصدر تأييداً لحظرهم ومحاكمتهم وتشديد محاسبتهم، وكل الحملات تُشن ضدهم، حتى الولاءات تُستدعى من عمق التاريخ لتذكير الجميع بأن اللعبة الإقليمية لم تعد تحتمل ازدواجية الخطاب أو اللعب على التناقضات، في هذه البيئة، يُختصر الإخوان في خطاب واحد: مصدر قلق، ورافعة محتملة لمشروع إقليمي يزاحم الأنظمة في شرعيتها الرمزية والتاريخية.
ليس الإخوان هم من تغيّروا، بل الرؤية إليهم، وفي المشهد العربي الراهن، حيث تختلط المعايير وتتشابك التحالفات، قد لا يكون السؤال هو: ماذا نريد من الجماعة؟ بل: ماذا نريد من الدولة نفسها؟
لكن في رقعة أخرى من الخريطة، حيث تطل الجبال على ممرات بحرية إستراتيجية، يبدو المشهد مختلفًا، هناك، لا تُفتح ملفات الماضي ولا تُستحضر أدبيات التنظيم، بل يُكتفى بإعادة تقديم الجماعة بلبوس جديد، باسم مختلف، وبوظيفة محددة: مقاومة الخصم المشترك، وتحت هذه الذريعة، يُعاد إدماج من كانوا يومًا في دائرة الشبهة إلى مربع الشراكة، ولو من باب الضرورة، في انتظار تغير موازين القوى.
التناقض في المواقف ليس وليد لحظة، بل هو سمة ملازمة لمقاربات واقعية، ترى في الجماعة تارةً عدوًا أيديولوجيًا يجب اجتثاثه، وتارةً أخرى حليفًا مرحليًا لا غنى عنه، ما دام قادرًا على ملء فراغ الدولة أو ممارسة الضغط على طرف ثالث، وهذه الواقعية، وإن بدت في ظاهرها سياسية محضة، إلا أنها تخفي في طياتها أزمة أعمق: غياب إستراتيجية ثابتة في التعامل مع التنظيم العابر للحدود.
ما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا هو أن الجماعة نفسها تدرك هذا التناقض وتستثمر فيه، فهي تتقن التكيف مع المحيط، وتعرف متى تتحدث بلغة الدولة ومتى تعود إلى خطاب “الرسالة”، وهي في ذلك لا تفعل أكثر من عكس صورة الفوضى في مواقف من يضعهم أحيانًا في خانة الأعداء، وأحيانًا في خانة الحلفاء التكتيكيين، لقد بات التنظيم يملك قاموسًا مزدوجًا لكل بلد، وخطابًا يفصّل على مقاس كل عاصمة، في لعبة البراعة فيها لا تقل عن براعة خصومه في صناعة الاستثناءات السياسية.
في العواصم التي تروّج لخطاب الحرب على التطرف، تجد المنابر الإعلامية تشن هجومًا مستمرًا على الإخوان في بلد، بينما تصمت عنهم تمامًا في بلد آخر، أو تكتفي بالتلميح إذا ما اقتضت الظروف، وفي أحيان نادرة، يتم تقديم بعض قياداتهم كجزء من تحالف وطني، حتى وإن كانوا يُدرجون في الوقت ذاته على قوائم التشدد في بلاد أخرى، وهذه المفارقة لا تضر بصورة الدولة فقط، بل تمنح التنظيم شرعية رمادية، يصعب نزعها حين تقرر السلطة أخيرًا توحيد خطابها.
اللافت أن هذا التناقض لا يقتصر على القرار السياسي، بل يمتد إلى الخطاب الديني والأمني، حيث يُطلب من بعض الجهات الأمنية التعامل مع الجماعة كخصم لا يمكن التفاوض معه، في الوقت الذي تنسج فيه مؤسسات سياسية أو استخباراتية علاقات خلف الستار مع ممثلين عن الجماعة نفسها في مناطق أخرى، بذريعة أن “الأرض لا تحتمل الفراغ،” وما بين تشديد في الشمال، وتنسيق في الجنوب، تتآكل ثقة الشارع بوضوح الخطاب ومصداقية المواقف.
قد تكون السياسة في النهاية فن الممكن، لكن الممكن لا يجب أن يكون خاليًا من المبادئ، فاستمرار هذه الازدواجية لا يُضعف التنظيم بقدر ما يُربك خصومه، ويُفقدهم أدواتهم الأخلاقية في المواجهة
ربما كان من السهل تفهّم المقاربة المرحلية حين تكون مدفوعة بضرورات ميدانية صارمة، لكن ما لا يمكن تجاهله هو أن هذه المقاربة تحوّلت مع الوقت إلى سياسة مستقرة، يطغى عليها التكتيك، وتغيب عنها الرؤية طويلة المدى، بل إن بعض العواصم باتت تتعامل مع الجماعة وفق ميزان السوق: إن احتاجت إلى قوة على الأرض، يتم تلميع الصورة وتليين الخطاب، وإذا انتفت الحاجة، تعود إلى قاموس الاتهام والتخوين، ولعل إخوان اليمن أنموذج صارخ هو الذي بدد مكتسبات “عاصفة الحزم” وهو الذي مازالت بعض العواصم تصر إصراراً ليس فقط على شرعنته بل على تمكينه ولو على حساب مكافحة الإرهاب في المحافظات الجنوبية التي يفترض أنها محررة.
في زحام هذا التناقض، يجد الكثيرون أنفسهم أمام معضلة أخلاقية: كيف يمكن محاربة فكر في مكان، والتحالف مع حامليه في مكان آخر؟ وهل يمكن لخطاب يحارب التنظيم في شوارع العاصمة أن يُقنع الناس بعدالته، بينما صوره تُرفع على المدرجات في مدينة أخرى وتُقدَّم قياداته بوصفهم “فرسان المرحلة”؟
قد تكون السياسة في النهاية فن الممكن، كما يقول الكلاسيكيون، لكن الممكن لا يجب أن يكون خاليًا من المبادئ، فاستمرار هذه الازدواجية لا يُضعف التنظيم بقدر ما يُربك خصومه، ويُفقدهم أدواتهم الأخلاقية في المواجهة، وما لم يتم ضبط البوصلة، وتوحيد المعايير، فإن المشهد سيظل يدور في حلقة مفرغة: صراع مع الجماعة هنا، وتنسيق معها هناك، في لعبة لا يعرف أحد من الذي يُوظّف فيها الآخر.
الحصيلة، ليس الإخوان هم من تغيّروا، بل الرؤية إليهم، وفي المشهد العربي الراهن، حيث تختلط المعايير وتتشابك التحالفات، قد لا يكون السؤال هو: ماذا نريد من الجماعة؟ بل: ماذا نريد من الدولة نفسها؟ وهل نحن بصدد بناء منظومة تتعامل مع الأيديولوجيا كقضية مصيرية، أم فقط كملف تكتيكي يُفتح ويُغلق بحسب الحاجة؟ تكلفة ازدواجية المعايير أكبر من استخفاف بعض العواصم بعقول شعوبها التي هي أصلاً غارقة في الأيديولوجيا الإخوانية وتعيش عصبياتها المذهبية والقبلية.
هاني سالم مسهور