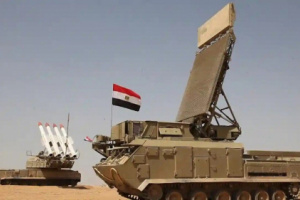مقالات
"الفلول المذعورة".. "فبأي حديثٍ بعده يؤمنون"

(الفلول المذعورة) من كتابي القادم "فبأي حديثٍ بعده يؤمنون"
إن الذين ابْتَنَوا عروشًا من الملح، ثم تربَّعوا فوقها في غفلةٍ من الزمان وغفوةٍ من الدهر، وفي خطأ تاريخي فادح آن الأوان لتصحيحه على الفور ودون تسويف؛ قد بدأوا يشعرون بالخوف والهلع، مِن أنْ تُمطِرَهم سماءُ القرآن والعقل وابلًا طيِّبًا، فتذوبَ عروش الوهم تلك؛ ليتساقطوا تباعًا، ثم يِفِرُّوا كفلول مذعورة، ويبادروا بالبحث عن مخبإٍ يواريهم عن أعين الناس؛ فالمسلمون لن يرحموهم، وكيف يرحمونهم وقد نَصَّبُوا أنفسَهم نُوَّابًا عن الله، وظِلالًا له في الأرض؛ فوقَّعوا عنه، وتكلموا باسمه؟! وقد فعلوا ذلك غيرَ صادِرين عن كتابه المجيد، ولا ناهلين من نبع وحيه الذي هو – وحدَه – القول السديد.
بل إنهم قد عَمَدُوا إلى اتخاذ القرآن وراءهم ظِهرِيًّا، ليفتحوا جُعَبَهم كما يفعل السحرة والحُوَاة والمشعوذون، فيمتلئ الجو غبارًا؛ لأنهم أخرجوا من تلك الجعب كتبًا صفراء مغبرة متيبسة كتيبُّس "أدمغتهم" ولا أقول "عقولهم"؛ فما ثَمّ.
وقد لجأوا إلى تلكم الكتب لأنهم وجدوا القرآن يَفِيض بيُسر الدين وسماحة الشريعة ورحمة الخالق ورأفة الرسول؛ فلم يَرُقْ لهم ذلك، إذ كيف سيتحكَّمون في عقول الناس ويقودونهم كالقطعان الضالة؟!
فالخالق الذي أنزل الكتاب المستنير، وأرسل السراج المنير، قد رحم ضعف مَن خَلَقَهم، وهو أعلم بهم من أنفسهم، وأَرأَفُ بهم من أمهاتهم؛ فلم يجعل عليهم في الدين الذي ارتضاه لهم من حرج، قال سبحانه: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج) المائدة، 6. وقال جلّ شأنه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) الحج، 78.
فكان لا بد أن تنقيح تلكم العقول المريضة، والنفوس المظلمة المبغضة للناس وللحياة، عن فكرةٍ نَفَثَ فيها الشيطان نفسه، وكان عَرَّابَها وابنَ بَجْدَتِها. وهي أن يكتموا ما أنزل الله، ولا يتخذوه منهج حياة كما أراد الله له أن يكون، بل أن ينغمسوا حتى آذانهم الصماء في أوحال تلك الكتب؛ ليُخرِجوا منها شجرًا زقُّومًا وماءً حميمًا، ويطعمونا ويسقونا إياهما، غيرَ ملتفتين ولا عابئين، بتلك الرائحة الكريهة التي تزكم العقول قبل الأنوف، والمتمثلة في المصادمة العنيفة، والتناقض المروِّع، والتشاكس المنفضح، بين ثرثرات وهمهمات وهلوسات واضِعي بعض المرويات على لسان النبي الأكرم، وبين كتاب الله المجيد الذي قال عنه مَن أنعم به علينا: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِين) يونس،57. وقال عمّن أنزل على قلبه الطاهر: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا) الأحزاب، 45-46.
كما بَشَّرَنا بقدومه الذي أضاءت له الأرض قائلا: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم) التوبة، 128. ومعنى (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ) أي إنه - صلى الله عليه وسلم - يجد في نفسه الشريفة ضيقًا وألمًا حينما يرى المسلمين قد أصابهم ولو شيء يسير من المشقة، كيف لا وقد خاطبه ربه بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين)؟! الأنبياء، 108.
وبعد كل ما سبق من شأن ربنا الأرحم ورسولنا الأكرم، يقوم أولئك المفتئتون عليهما بالنظر إلى كتاب الله، فلا يجدون عليه مدخلًا ولو كمغرز الإبرة؛ فلا يعجبهم ذلك، غير أن في كتبهم المتخشبة كعقولهم - إن كان ثَمّ - بدل المغرز فجوات وفجوات، بل بوابات وبوابات، لا رقيب عليها ولا حسيب.
ونعود لأصحابنا "المستشيخين" لنقول: إنهم لم يرضوا بأن يكون الإله رؤوفًا والرسول رحيمًا؛ فاخترعوا وخَرَقُوا إلهًا آخرَ لا نعرفه في كتاب ربنا، وهو إله شرس كاره لخلقه ناقم عليهم، لا هَمَّ له إلا أن يُلجِئَهم إلى الكفر، فيبعث لهم بكائن خرافي آخر الدهر اسمه الدجال؛ ليضل الناس بدل أن يهديهم.
وهو إله ساديٌّ يحب إيلام الناس وتعذيبهم دون جريرة؛ فالميت الذي ناحت عليه بَوَاكِيه، معذَّبٌ في قبره دون ذنب أتاه أو إثم اقترفه أو سيئة اجترحها أو خطيئة كسبها (البخاري 1292، مسلم 927 – وقد اعترضت عليه أمنا عائشة وصححه القوم). بينما إلهنا نحن يقول: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الانعام، 164 - الإسراء، 15 - فاطر، 18 - الزمر، 7 - النجم، 38.
وهو إله يعذب عباده - حتى لو كان الرسول نفسه - بسكرات الموت المؤلمة (البخاري، 6056)، بينما يقول إلهنا: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) فصلت، 30-32.
ويحب أن يعذبهم بهول القبر المفزع (الترمذي، 1071)، أما إلهنا فأخبرنا أن الموتى نائمون، وكيف يعذَّب النائم؟! فقال جل شأنه على لسان الكفار يوم النشور: (يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا) يس، 52.
كما يحلو له أن يؤلمهم يوم الحشر، وذلك بأن يسلقهم بشمس لا أعلم من أين أتى بها القوم (مسند أحمد، 17109)، في حين أن الشمس قد لُفَّت وذُهِبَ بنورها من قبل، قال تعالى عن يوم القيامة: (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) التكوير، 1. حيث تدنو فوق رؤوسهم فيغرقوا في عرقهم (لماذا يعرقون فقط ولا يحترقون؟!).
ثم هو إله "يستظرف" على الخلق، فيأتيهم متنكرًا كأحد المراهقين المولعين بطقوس الهالوين (البخاري، 6910)، فلا يعرفونه، فيسألهم ماذا يجب عليه أن يفعل ليتصدقوا عليه ويعترفوا بأنه ربهم، فيطلبون منه أن يحسر ثوبه إلى ركبتيه ويكشف عن ساقه؛ لأنهم - بزعم مُدَوِّنِي المرويات - يعرفونه بساقه، ولا أعلم متى رأوا تلك الساق حتى يجعلوها أمارةً يعرفون بها ربهم الذي (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير)!! الأنعام 103.
كما اختلقوا وخرقوا رسولًا لا نعرفه - نحن المسلمين - في كتاب ربنا؛ فهو جبار عُتُلّ، يرجم الناس بالحجارة حتى الموت دون أن يوحي إليه ربه أمرًا كهذا. ثم هو يقذف المسلمات في أعراضهن وأعراض محارمهن، ويصفهن بالزواني لأنهن أحببن العطر فتعطّرن (مسند أحمد، 19271).
ثم هو رجل يلعن كل حين؛ فمن نتفت شعيرات من حاجبيها تجمُّلًا فهي ملعونة (الطبراني، 9358)، ومن خانها جمال شعرها فاتخذت شعرًا مستعارًا تتجمل به ولا تدلس على خاطِب، فهي ملعونة (البخاري، 4887)، وما أكثر ما يلعن ذلك الرجل الذي ننكره ولا نعرفه!!
ولولا خوفي مِن أنْ أجترحَ تكفير المسلم لقلت لهم: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ).