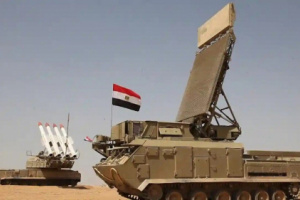تقارير
تحول مسار الثورات العربية من إسقاط النظم إلى تفكيك الدول؟:

استهدفت الثورات الجماهيرية في عدة دول عربية منذ مطلع عام ٢٠١١ إسقاطَ أنظمة حكم عجزت عن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة باضطراد منذ عدة عقود، كما فشلت في تلبية تطلعات أجيال صغيرة اعتبرت قضايا الحريات وحقوق الإنسان مسألةً جوهريةً لحياتها ووجودها دون استعداد منها لقبول المقايضة التي قبلت بها أجيال أسبق منها، والتي بمقتضاها يُمكن التنازل عن الحرية وحقوق الإنسان مقابل تحسين الوضع الاقتصادي-الاجتماعي، معتبرة أن من حقها أن تطالب بطرفي المقايضة معًا.
غير أن هذه الثورات في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، لم تؤدِّ إلا إلى تحقيقٍ جزئيٍّ بإسقاط رؤساء حكموا في هذه البلدان دون أن يسقط النظام الحاكم بأكمله، باستثناء سوريا التي بقي بشار الأسد فيها عصيًّا على السقوط رغم خسارته سيطرته على أنحاء واسعة من البلاد في إطار حرب أهلية تحولت إلى حربٍ إقليميةٍ بالوكالة لا يبدو أن هناك أفقًا قريبًا لإنهائها.
لقد أظهرت الحالات الخمس المشار إليها أن سقوط الأنظمة لا يضمن تحولا سريعًا لتحقيق أهداف هذه الثورات الجماهيرية، بل إنه يدفع هذه المجتمعات إلى التشتت وضياع الدولة (حالة ليبيا واليمن)، أو إلى حربٍ أهلية بلا نهاية (سوريا)، أو إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار (مصر وتونس)، مع الأخذ في الاعتبار أن الحالتين الأخيرتين يمكن تحت شروط معينة أن تتحول إلى الحالة الأولى. إن محاولة تفسير هذه الظاهرة تمر عبر إلقاء الضوء على ثلاث قضايا مشتركة بين هذه المجتمعات الخمس.
القضية الأولى: أزمة الدولة القومية.
شكلت الدولة القومية في العالم العربي، سواء كانت ملكيات أم جمهوريات، صدى متأخرًا زمنيًّا لفكرة دولة المواطنة التي نشأت في أوروبا في أخريات القرن التاسع عشر دون أن تكون -من حيث تكويناتها الاجتماعية ومستوى تطورها الاقتصادي والسياسي- قابلة فعليًّا لمحاكاة النموذج الأوروبي الناجح، بل إن دولة المواطنة أو الدولة القومية تعرضت في أوروبا ذاتها لاختبار صعب مع صعود النازية والفاشية، الأمر الذي أدى إلى نشوب الحربين العالمية الأولى والثانية، وبعدها تم حسم الصراع بين فكرة الدولة القومية وبين فكرة الإمبراطورية التي تقوم على تحكم عرقيات تدعي التفوق على غيرها لصالح فكرة الدولة القومية، ورغم ذلك بدا الانقسام الأيديولوجي عالميًّا بين معسكر الدول الغربية الرأسمالية وبين الإمبراطورية الشيوعية بمثابة تهديدٍ ممتدٍّ لفكرة الدولة القومية، وكان سقوط النموذج السوفيتي وتفكك منظومة الدول الشيوعية بمثابة المرحلة الثانية من انتصار الدولة القومية رغم ما صاحبها -ويصاحبها حتى الآن وربما لفترة زمنية قادمة- من محاولات لتوسيع رقعة التفكك (حالة أسكتلندا في المملكة المتحدة، والصراع العرقي في بلجيكا، والانقسام المماثل في أوكرانيا).
وبمعنى أكثر وضوحًا فإن الدولة الوطنية أو دولة المواطنة المرتبطة نظريًّا بالدولة القومية وبفكرة الإدارة الديمقراطية للتنوع الثقافي، ومن خلال حتى البيئة التي نشأت فيها؛ لم تستطع مواجهة الانقسامات الأولية (العرقية، والدينية، والمذهبية)، ولولا تطور مستوى النمو الاقتصادي الاجتماعي هناك لكانت الصراعات قد عصفت بالقارة بأكملها، وتدل حالة البلدان الأقل تطورًا في أوروبا مثل يوغسلافيا السابقة على مدى فاعلية الانتماءات الأولية، وقدرتها على إفشال فكرة دولة المواطنة.
وبطبيعة الحال كان لنموذج الدولة القومية في العالم العربي أن يواجه إشكاليات أكبر، نظرًا لضعف تطور بلدانه اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، وقد تعمقت الأزمة مع فشل نظم الحكم التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية عن تحقيق أيٍّ من وعودها لشعوبها، وبالتالي فإن سقوط الأنظمة في الدول الخمس السابق ذكرها كان ترجمة لأزمة مزدوجة؛ أزمة النجاح المحدود لهذا النموذج في القارة التي نشأ فيها، وأزمة تشوه النموذج نفسه في البلدان العربية.
بالإضافة إلى ذلك كله فإنه على الصعيد النظري تبدو الدولةُ القومية ودولة المواطنة وفكرة الإدارة الديمقراطية للتنوع الثقافي فيهما نتاجًا للحضارة الصناعية التي أنجزت أهدافها في بعض المناطق من العالم لتَخْلُفُها حضارة جديدة في طور التشكل، وهي حضارة عصر الاتصالات، وظاهرتها الأبرز "العولمة " التي أشعلت ثورة قيمية عالمية لا تتناسب مع التفاوتات القائمة في درجات التطور الحضاري في العالم المعاصر.
القضية الثانية: تآكل الشرعيات التقليدية.
عرف العالم العربي فكرة الدولة القومية نتيجة تطورات عدة أفرزت حركات وطنية طالبت بالتحرر من الاستعمار الأوروبي، وهو ما تمكنت من تحقيقه في العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية، وقد تأسست شرعيةُ نُظُم الحكم السابق ذكرها في البلدان الخمسة على أساس هذا الإنجاز حتى لو تأخر بعضها في الالتحاق بهذا التأسيس (حالة اليمن ١٩٦٢، حالة ليبيا بعد إسقاط الملكية عام ١٩٦٩)، ولم يكن الفشل في قضايا التنمية الاجتماعية-الاقتصادية وحده السبب في تآكل شرعية معظم هذه الدول؛ بل أدى فشل بعضها في الحفاظ على السيادة الوطنية إلى مزيدٍ من هذا التآكل (حالة مصر وسوريا في أعقاب هزيمة يونيو ١٩٦٧)، ومن ثمَّ كان عجز هذه الأنظمة عن تجديد شرعيتها سببًا في تراكم الغضب ضدها من كافة طبقات المجتمع، باستثناء حلقات ضيقة منه تحالفت مع هذه النظم لتحقيق مصالحها، وتسببت في مضاعفة انهيار شرعيتها نتيجة فسادها وأنانيتها.
القضية الثالثة: غياب البديل.
احتكرت الدولة في النماذج الخمسة المشار إليها الحياة السياسية، إما عبر اعتماد سياسة الحزب الواحد (حالة مصر في الفترة ١٩٥٣-١٩٧٦، وتونس حتى عام ١٩٨١، واليمن حتى عام ١٩٩٠)، أو نموذج الحزب القائد الذي يقود تحالفًا من أحزاب أخرى موجودة على الورق فقط (سوريا في ظل حكم حزب البعث)، أو عبر حالة غامضة وغير محددة (نظام اللجان الشعبية في ليبيا حتى سقوط القذافي عام ٢٠١١). ففي كل هذه التجارب منعت الدولة ظهور البديل الذي يمكنه ملء الفراغ في حالة زوال النظام الحاكم، أو ظهور أزمة داخله.
وحتى بعد ظهور التعددية الحزبية في بعض هذه البلاد منذ السبعينيات وما بعدها من القرن الماضي، بقيت التعددية الحزبية مقيدةً بحيث تعطي مسحة زائفة لنظام يدعي الديمقراطية دون التزام حقيقي بجوهرها، ومن ثم غاب البديل الذي يمكنه تسلم السلطة في حالات الأزمات الكبرى، بل إن التضييق الذي مارسته الدولة على هذه الأحزاب في النماذج الخمسة المشار إليها أدى في فترة لاحقة إلى هروب الجماعات السياسية إلى مؤسسات المجتمع المدني (جمعيات أهلية، ومنظمات حقوقية وتنموية) زادت من تشوه التجربة السياسية برمتها، وهو ما أدى في النهاية إلى فشل الأحزاب السياسية والجماعات المسيسة في المجتمع المدني عن تشكيل البديل المناسب للأنظمة الحاكمة التي تعرضت لهزة شديدة منذ عام ٢٠١١.
وتفاعلت القضايا الثلاث -السابق ذكرها- في إطار بيئة عاصفة، سواء على الصعيد الحضاري الشامل، أو على صعيد التفاعلات الداخلية في كلٍّ منها، وكانت ثورات "الربيع العربي" كاشفةً لعمق الأزمة التي أنتجها هذا التفاعل، ولا يزال، وبدلا من التحول صوب الديمقراطية بمعناها الضيق (الإجرائي) أو بمعناها الواسع (إدارة التنوع الثقافي: الديني والمذهبي والعرقي إدارة ديمقراطية) وقعت هذه البلدان في أتون حالة من الفوضى ما زالت تهدد بعضها بالانهيار (حالة مصر)، أو أوصلتها إلى حربٍ أهليةٍ ممتدةٍ (سوريا وليبيا واليمن)، أو توافقت على مسار مؤقت ما يزال في حاجة لاختبار مدى نجاعته (حالة تونس).
لقد أصبحت الدولةُ الوطنية المأزومة في كل البلدان الخمسة على اختلاف عمق هذه الأزمة بمثابة شهادة على أن عملية التحول الديمقراطي إذا ما أُجريت في ظروف أزمة متعددة المستويات تهدد بقاء الدولة بدلا من دمقرطتها، ودفعها في اتجاه مسار أكثر تقدمًا بالمعايير الدولية السائدة، وهي حالة تُنذر بمخاطر هائلة على الاستقرار والأمن الدوليين.
* سعيد عكاشة. المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية .
* مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية